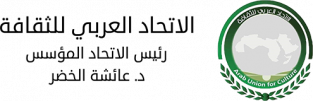صلاح بوسريف ( المغرب )
قليلون النقاد العرب، اليوم، من هم في مستوى ما يكتب من شعر عربي معاصر.
الذين تربوا على شعر “الرواد”، لم يخرجوا منه، استنفذ مفاهيمهم، ومناهجهم، وذائقتهم في قراءة وتلقي الشعر. ما تزال “القصيدة”، مفهوما وبناء، هي ما يحكم رؤية هؤلاء للشعر، في اختزاله، في دوال ” القصيدة”، أو ما تبناه “الرواد” من دوال، تحدرت إليهم من ماضي “القصيدة” التي ظنوا أنهم انقلبوا عليها. وقد اعتبرتهم سلمى الخضراء الجيوسي، بقوا رهائن لهذا المثال، ولم يخرجو إلا عن بعض دواله، فقط.
الشعر اليوم، نأى بنفسه عن سياقات الماضي، عن البنية الأم ل” القصيدة”، أعني الشفاهة والإنشاد، وصار يميل إلى الكتابة، إلى التركيب المعقد للصور والإيقاعات، وإلى الجمل المتواصلة ذات التوزيع اللولبي، جمل وتراكيب لا تفتأ تتناسل، إيقاعاتها تغير وتائرها، بنوع من الموسيقى الأوركسترالية التي تشي بالانقال من سياق إلى آخر، دون فواصل ونقط، أو باستعمال الفواصل والنقط، وغيرها من أدوات الترقيم، التي هي تعبيرات كتابية بامتياز، علامات تظهر على الصفحة، وتحدد نوع السرعة أو البطء الذي تسير به الجملة، أو الصورة. [نص متاهة في لغته وإيقاعاته].
في الشعر العربي الراهن، علينا، أولا، أن نخرج من غمامة “الرواد”، وننظر إلى ما يجري في الغابة، دون أن تحجب عنا الشجرة الغابة، أو تمنع عنا رؤية ما فيها من شموس وظلال. وثانيا، أن نقرأ شعرهم في ضوء ذائقتهم وتكوينهم الشعري والجمالي، وعلاقتهم بماضي الشعر، أي ب”القصيدة”، وثالثا، أن نتحرر من سلطتهم، بقراءتهم ومعرفة طبيعة تجاربهم وما اقترحوه من تصورات نظرية، وما أحدثوه من اختراقات وانتهاكات، لا أن نبقى أسرى لما قيل وكتب عنهم، أو ما تعلمناه في المدارس والجامعات، مما حجب عنا شعرهم، وأعمانا عن رؤيته بما يكفي من وضح نقدي. فمواجهتنا لنصوصهم، في ضوء ما استجد من معرفة بالشعر وبنقده، وما جرى في المفاهيم والتصورات نفسها من تبدلات وتغيرات، هي وحدها ما يمكن أن يقربنا منهم، بالتحرر منهم، والإضافة لهم. لا أن نكون عالة عليهم، بقدر ما هم عالة علينا. كما علينا أن نخرج من سلطة الشخص، إلى اكتشاف قراءة ومواجهة النص. فالنقد السائد، هو نقد أشخاص، لا نقد نصوص وتجارب.
نحتاج إلى نقد يخرج من النصوص ذاتها، لا إلى نقد مؤسس، في تصوراته ومفاهيمه وأدواته، على نصوص وخطابات تنتمي إلى ذوق وحساسية، أو رؤية غير ما تجري به نصوص اللحظة التي نحن فيها. وهذا النقد، ما زال قليلا، عزيزا، غلبت عليه الانطباعات الصحافية والإعلامية، وجرى تشويش الشعر، وابتذال ما فيه من اختراقات، إلى الدرجة التي جعلت النقد امتداحا، وتبادلا للقبل، كما يحري في وسائل التواصل الاجتماعية، بدل أن يكون مؤسسا على رؤية نقدية صادرة عن وعي ومعرفة بما يقتضيه النقد من معارف، ومن أسس فكرية جمالية، بدونها، سيظل الحابل مختلطا بالنابل، لا مسافة ولا فرق، زيد هو نفسه عمر، كلاهما يتبادلان الأقنعة، أو يلعبان نفس الدور بتغيير الأقنعة فقط. وهذا، في تصوري، هو عطب النقد الشعري العربي الراهن، رغم أنني أومن أن هذا النقد يتأسس على يد القليلين ممن يعملون بهدوء وبعمق، كما حدث مع المبرد الذي كان بين أوائل النقاد القدامى، ممن انتصروا في القرن الثالث الهجري للشعر المحدث، و لأبي تمام، تحديدا، في مقابل الشعر القديم، الذي كان النقد ينتصر له، لا لشيء، إلا لأنه سابق زمنيا عن غيره، وهو ما عبر عنه بعض النقاد بقولهم “لا أفضل القديم على محدث، ولا المحدث على قديم، إلا بالإجادة”، ما تسميه الشعرية المعاصرة عند ميشونيك ب”القيمة الشعرية”.
ما لم ندخل إلى النصوص، نكشف ما تحفل به من “عمران” أو “خراب”، لن نخرج من هذا التعميم والتعويم، وتبجيل الأشخاص، فيما النصوص تبقى منطوية على نفسها، تنتظر زمنها، واليد التي ستزيح عنها غبار النسيان.