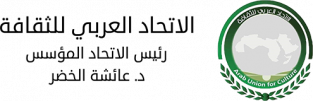إنه الوادي المخيف الذي لا أحد يجرؤ على الدخول إليه،
وكل من يُصادفه في طريقه يلتف حوله ولا يعبره.
كان هذا المكان المظلم حتى في وضح النهار – لتشابك أشجاره والتفافها حول بعضها بكثافة-
مسكناً للجن، وحتى أشجع الرجال لا يُغامر بالدنو منه. يروي أهل الجبل واقعة (عبدالرحمن الدقداق)
كموعظة لمن تسول له نفسه وطء تراب الوادي المسكون. يقولون إن هذا الفلاح القوي البنية حمل فأسه،
ودخل وادي الضجوج وقت الزوال، ناوياً قطع شجرة شوحط، وبينما هو يتحسس جذوعها ليختار أجودها ليصنع من خشبها هراوات يبيعها في السوق،
إذا به يلحظ جدياً وبره أسود، يجلس مقرفصاً بهدوء على العشب. أُعجب بقرنيه، كانا مستديرين كهلالين، يسلبان اللب من روعتهما. لاحظ أن الجدي كان ينظر إليه وعلى فمه ابتسامة بشرية! فكر عبدالرحمن في أخذ الجدي، وقدّر أن مذاق لحمه مطبوخاً في القدر سيكون طيباً. اتسعت ابتسامة الجدي وامتدت إلى شدقه الأيسر،
وكأنه يسخر من الخواطر التي دارت في خُلد عبدالرحمن. علّق فأسه على أحد الأغصان، وتقدم بثبات نحو الجدي، انحنى وبسط ذراعيه ليحمله، لمح عبدالرحمن تغضّن جفني الجدي ونظرة نارية من حدقتيه، ثم وثب عليه وضربه بأحد قرنيه على خده ولاذ بالفرار. ومنذ تلك الساعة عاش عبدالرحمن ألوقاً.
في الليل تشاهد قرى الجبل أضواء فوانيس تومض كالنجوم من وادي الضجوج، وراقب القرويون أشكالاً محددة كانت تتكرر نمطياً. الحاج (حيدر أبوالوقت) الذي له بصرٌ بعلم الفلك، أخبرهم أن الجن يرتبون فوانيسهم في الوادي كما تتوضع في السماء نجوم برج الجدي. في النهار يسمع الناس باستمرار صوت امرأة تطلق صرخة رهيبة طويلة،
ترجفُ لها القلوب “آآآآووووم”. الصرخة في بدايتها قوية جداً، ثم تخفت بالتدريج، وكأنما صاحبتها قد تردت من شاهق إلى قعر وادي الضجوج. فجأة ودون أي ارتباط بوقت محدد تردد الجبال صدى صرخة المرأة الساقطة.
ويقال إنه يمكن توقعها مرة واحدة على الأقل قبل غروب الشمس مباشرة. يتناقل أهل الجبل أن صاحبة الصرخة هي (سلمى بنت الزواك) التي مضت بقدميها إلى وادي الضجوج قبل مائة عام، وتسلقت شجرة ذرح لتقطع حطباً من أغصانها، وكان الوقت بين الضحى والظهيرة. في المساء خرج زوجها وأولادها للبحث عنها، ولدها الأكبر وحده الذي ساوره الشك، فذهب يبحث عنها في وادي الضجوج، وجدها مُلقاة في مجرى غيل ماؤه قليل كدر،
كانت عاجزة عن الحركة، تحتضر. كان في فمها حبات ذرة سليمة لم تهرسها بعد بأسنانها. قام الولد باستخراج الذرة من فمها، ثم سقاها بكفه من ماء الغيل. أخبرته أن امرأة مُعلقة في الهواء دفعتها من فوق شجرة الذرح. أوصته أن يزغرد إذا رآها. حملها الولد بين ذراعيه، وقبل أن يصل بها إلى البيت، كانت قد فارقت الحياة، والشمس قد غاب نصف قرصها في البحر البعيد. يزعم واحد من أحفادها اسمه (صوفي) أنه دخل مرة إلى وادي الضجوج،
فرأى امرأة تمشي في الهواء متجهة نحوه، رجلاها وأذناها كرجلي وأذني العنزة، فتذكر وصية جدته، وزغرد بطول صوته، ولدهشته تحولت المرأة إلى شعاع، وتلاشت كأن لم تكن. وادي الضجوج هو الضلع الأعوج المفقود من أضلاع الجبل، أعلاه حيد صخري أملس كحد الشفرة، لا يجرؤ حتى الضبع على الاقتراب من حافته،
وأسفله غيل يرشح من بين تجاويف تعشش فيها الثعابين، ويتحدر منه ماء فيه بقع طحلبية ضاربة للسواد. والقرويون يتجنبون الشرب منه لمذاقه المر. في الليالي التي يغيب فيها القمر معربداً في الصحراء، يحدث أن يضل البعض طريقه، ويدخل بطريق الخطأ إلى وادي الضجوج.. كل الذين انتهكوا حرمة الوادي ليلاً تعرضوا للرجم، والمحظوظ منهم من يسرع بالخروج قبل أن تصيبه الحجارة، وأما المتمادون منهم فإنهم يتلقون وابلاً كرش المطر،
فيهربون والدماء تنزف من أجسادهم، وهؤلاء المنكودين يظلون لسنوات طويلة بعد شفاء جروحهم، يعانون من الآثار النفسية لهجوم الجن. يتحدث أهل الجبل عن المختفين.. وهم أشخاص دخلوا إلى وادي الضجوج ولم يرهم أحد بعد ذلك أبداً. باستثناء رجل واحد، يحمل اسماً غريباً (جمل الليل) عاد بعد غيبة طالت ثلاثين عاماً. سعيت إليه وقابلته، وتأكدت من قصته بنفسي. قال إنه كان معروفاً في الجبل بسمعته كسارق داهية، مصيبة الله، يسرق الزوجة من تحت زوجها وهو يضاجعها دون أن يشعر به الزوج! قال إن القرويين لقبوه ب(المطحنة) لأنه كان إذا تسلل إلى أرض أحدهم، يقتلع الثمار التي في رؤوس الأشجار، والمنطرحة على الأرض، والمكبوسة في جوف التراب، فلا يكاد يسلم من يده أخضر أو يابس، فشبهوه بالمطحنة التي تطحن كل ما يسكب فيها. ولما رأى والده أن الناس يُعيرونه بهذا اللقب، أطلق عليه لقب (جمل الليل).
قال إنه بدأ يُزاول السرقة وعمره لا يزيد عن العشر سنوات، والسبب أن أمه كانت حاملاً وتوحمت أن تأكل الباباي، وكان والده وقتها في شدة، وعاجزاً عن شراء حتى حبة زبيب، فخرج ليلاً وملأ سفطاً من ثمار الباباي. استمر لأشهر يُموّن البيت بالذرة البيضاء والحمراء والدخن والدجرة، وكانت أمه تغطي عليه، ولا يعلم والده من أين يتدفق هذا الخير، ثم عرف بالمصادفة، لما فاق من النوم في ساعة متأخرة من الليل وخرج ليقضي حاجته..
بعدها أدخل (جمل الليل) الفاكهة والبن والقات والليمون والفلفل الأخضر إلى قائمة مسروقاته، وحتى الكاذي والحماحم كانا يثيران شفقته فلا يفلتهما. وحين بلغ الخامسة عشرة من العمر، كان بإمكانه أن يحمل على ظهره من المسروقات ما يُعادل وزن رجل متوسط القامة. وضجت قرى الجبل من وطأته، ورُفعتْ عشرات الشكاوى إلى العامل (حاكم الجبل) إلى أن اضطر الأخير على حبسه في القلعة. ورغم حبسه وتقييده بأغلال خشبية ثقيلة يعجز عن احتمالها الفيل، فإنه استمر في غاراته الليلية، بالاتفاق مع حارس السجن الذي كان يُقاسمه نصف ما يسرقه،
وكانت هذه ضربة مزدوجة لملاك الأراضي الكبار، فهو من جهة كان ينتقم منهم بالإمعان في التعدي على مزارعهم، ومن جهة أخرى ينفض التهمة عن كتفيه، إذ لابد أن يكون السارق الذي أقض مضاجع أعيان الجبل شخصاً آخر غيره. قال (جمل الليل) إنه في المرة الأخيرة خرج من القلعة في ليلة مُعتمة، والسماء مفروشة بالغيوم، والظلام حالك لا قمر هنالك ولا نجوم، وما كاد يضع قدمه في عقبة (صفنين) حتى وقف شعر ذراعيه، وأحس بأن هناك كميناً منصوباً له. أطلق قناص تقديراً على الوقع الرتيب لخطواته رصاصة صفّرتْ بالقرب من صوان أذنه،
حتى أن هذه الأذن ظلت برهة تهتز كخرقة تلعب بها الريح. هرب بخطوات متعرجة، فأخطأته ثلاث رصاصات أخرى. ظلوا يقتفون أثره كالذئاب، فلما عرّج باتجاه وادي الضجوج كفوا عن مطاردته. كان (جمل الليل) متيقناً أن شجاعة رجال الجبل ستخور إذا قادهم إلى مَرْبَع الجن. ارتمى على أرض خضيلة قرب مجرى الغيل، وقال في سره إن الجن على مساوئهم يظلون أفضل ألف مرة من الإنس الذين مقتوه وسجنوه، وسعوا بكل قواهم لسلبه روحه. وتحت وطأة الشعور بالقهر، سالت من عينه اليمنى دمعة واحدة. لقد كان شديد الاعتزاز برجولته،
وحتى عندما ساقوه مُكبلاً بالأصفاد من قريته إلى القلعة، لم تذرف عينه دمعة واحدة. وتذكر متنهداً أن عليه العودة بسرعة البرق إلى القلعة، قبل أن يؤذن الفجر ويستيقظ السجناء ويفتقدوه، ومن ثم تنكشف حيلته، ويُفتضح تواطؤ السجان معه. رفع نفسه بصعوبة، رغم الإعياء الشديد الذي يشعر به،
وسجد مُكوراً راحته وأخذ يشرب من ماء الغيل، فلما ارتوى مدّد قامته، وبدا له أن الماء البارد قد أنعشه وجدد قواه. سحب نفساً عميقاً، وإذا به يشمُ رائحة شواء زكية للغاية، لم يشم في حياته مثلها أبداً. نظر في الاتجاه الذي تأتي منه الرائحة، فرأى بيتاً جميلاً مبنياً من الحجر، تتوسطه نافذة مفتوحة يشع منها ضوء قوي، وكان دخان الشواء يتصاعد منها. اقترب بخطوات خفيفة مُحاذراً إصدار أي صوت، ووقف في موضع مناسب لا يقع عليه الضوء، وفي الوقت نفسه يكشف له ما يجري في الداخل. رأى مخلوقات غريبة متدرنة، تشبه الكمأة، تتحرك بصورة عادية في الغرفة. ظل يراقبها مشدوهاً قرابة نصف ساعة، وطوال هذه المدة لم يشعر مطلقاً بالخوف منها.
كانت الكائنات الدرنية تجلس على مقاعد واسعة مريحة – وقتها لم تكن هذه المقاعد معروفة في الجبل – ثم رأى احدهم ينهض ويخرج، وبعد قليل عاد. كانوا يتكلمون ولا يفهم لغتهم، ولكن إيماءاتهم بدت له ناطقة بمعانٍ يعرفها. بين المقاعد لاحظ وجود مائدة مستطيلة، سطحها زجاجي، وضعوا عليه لحماً ملفوفاً في لفات رفيعة، بدا اللحم ناضجاً ينز منه الدسم، وتحت الزجاج وهج احمر لا تتصاعد منه أية شعلة. كانوا يمدون أيديهم متى عنّ لهم،
فيلتقطون لفة اللحم بملقاط، ثم يأكلون اللفة بقضمات صغيرة. لفتت انتباهه ستارة تظهر وتختفي، تشغل الجدار المواجه للنافذة بكامله. وكانت هذه الستارة تُظهر عالماً بأفق مفتوح، يدخلون ويخرجون منها بيسر. خمّن أنها عائلة مكونة من ستة أفراد، وما كانوا يرتدون أية ملابس، ومع هذا بكيفية لا يعرفها لم تكن عوراتهم مكشوفة. مع المراقبة المُتأنية والتدقيق في الوقفة والمشية، أمكنه أن يُفرّق بين الذكر والأنثى. إحدى هذه الدرنيات انتبهت لوجوده،
فسارت إلى النافذة وأطلت تتأمله. لم يتزحزح من مكانه، كان لديه يقين راسخ بأنه من المستحيل أن تراه وهو في الظلام، بينما يجهر الضوء عيني تلك الدرنية الواقفة التي تحاول رؤيته.
شيئاً فشيئاً أخذت ملامح الدرنية تتكشف، وانقشع عنها الغشاء الخارجي البني الرقيق، فراح يميز وجه فتاة لطيفة، قدّر عمرها بعشرين عاماً. خامره إيمان لا يعرف مصدره بأنها فتاة طيبة جداً ولا يمكن أن تؤذي ذبابة. ظلت تنظر إليه بثبات دون أن ترمش بعينيها فترة طويلة، ثم تركت النافذة فجأة، فانقبض قلبه وشعر بالحزن.
وبعد لحظات قصار وجدها تفتح باب البيت وتشير عليه بالدخول. لم يتردد، انطلق نحو الباب المفتوح، وهو يحس في قرارة نفسه بطمأنينة عميقة.
*وجدي الأهدل- كاتب يمني.