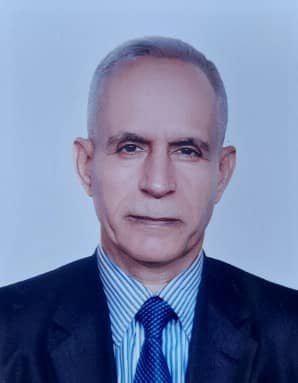#المرايا_التي_تخلعنا_عنها_السباعيات_التاريخي
نقف أمام عجائب الدنيا السبع، لا كما خلّدها التاريخ، بل كما تشظّت في الداخل:
هرمٌ يتهاوى في صدر الخيبة / حديقةٌ تتدلّى من وهم الطمأنينة / هيكلٌ ينهار تحت صلاةٍ منسية / تمثالٌ يبكي ملوحةً صامتة / ضوءٌ ينطفئ في ميناء القلب / مقامٌ تحترق فيه الأنا دون نداء / ومنارةٌ لا تضيء الطريق، بل تفضح التيه.
في مكانٍ ما تحت الضوء، حيث تتكوّر الحقيقة خائفةً من عُريها، تنبثق المرآة. لكنها هذه المرة لا تُريك وجهك… بل تُريك من تكون حين تنهار وجوهك. نكتب هنا لا لنُعجب بما نراه، بل لنواجه ما لا نحتمله. في هذا المرآة، نقف أمام #عجائب_الدنيا_السبع_القديمة، لا كما أرادها التاريخ
أن تكون شواهد على العظمة، بل كما تراها النفس حين تمرض، واللغة حين ترتجف، والذاكرة حين تكتبنا بخوف. كلُّ عجيبةٍ هنا مرآة، وكلُّ مرآةٍ تعكس ظلا من ظلال الذات المنكسرة . #كما_تتجلى_في_أعمال_عمر_أحمد_الحمود، نقرأ مؤلفات عمر لا بوصفها حكاياتٍ تروى، بل كنصوصٍ تتقاطع مع الرموز الكبرى للإنسان في سعيه للخلود والجمال والدهشة ثم تنهار أمامه حين تتآكل من الداخل. لم نأتِ لنحتفي، بل لنُزيح الغبار عن الأسطورة، لنكشف على سطحها تلك الندوب التي تركتها الهزائم الصغيرة في النفس البشرية. لقد اخترنا أن نربط كل تصدّع وجودي أو ارتباك إنساني، كما يتجلّى في قصص عمر، بإحدى عجائب العالم القديم. ليس لأنّ بينهما تشابهاً بصريّاً، بل لأنّ كليهما أُنجز بوهم الخلود، وَانْهار بحقيقة الإنسان.هنا لا نُفسّر بل نعكس. لا نؤرِّخ بل نغرق. نستخدم في كل مرآة بنيةً ثابتة/ عجيبةٌ قديمة نُعيد النظر فيها بعيون المرتاب. عملٌ قصصيّ من أعمال عمر أحمد الحمود يتقاطع معها في الرماد أو الحلم. / تأملٌ رمزيّ يكشف العلاقة الخفيّة بينهما. /ثم ملاحظة تفسيرية تُضيء ما انكسر. / كلّ مرآةٍ ليست مجرد تأمل، بل اختبار. اختبار للذات التي تقف أمامها، وبدلاً من أن ترى وجهها، ترى ظلّها حين كان يحاول أن يكون شيئاً ولم يقدر. هذه المرايا ليست قراءة نقديّة، ولا تقويماً للأثر، بل هي همسٌ داخلي في مواجهة النصّ حين ينسلخ من سطحه، ويتحوّل إلى صدى فينا. إنّنا لا نقرأ قصص عمر أحمد الحمود بوصفها مجرّد أدب، بل بوصفها بواباتٍ خفيّة نحو الإنسان المكسور الذي يشبهنا جميعاً. نُقابلها بالعجائب لا لنُكرّس الأسطورة، بل لنعيد مساءلة ما كنّا نظنّه خالداً:
الجمال، البنيان، الطمأنينة، المعنى. فكما أن العجائب اِنْهارت رغم عظمتها، تنهار في قصص الحمود أوهامنا الصغيرة: عن الثبات، عن الحب، عن الطمأنينة، عن المعنى. ليست هذه النصوص ترفاً رمزيّاً، بل محاولة لبناء سلّم من الرماد… لا نصعد به، بل نغوص عبره نحو مرآتنا الحقيقيّة.
#الْمِرْآةُالأُولَى: #الْهَرَمُ_الَّذِي_بَنَتْهُ_الْخَيْبَةُ
(تأمل في “الخيبة” لعمر أحمد الحمود).
لم يكن الهرمُ الأكبرُ معجزةً، بل جرحاً قديماً اختار أن يصمت بدل أن ينزف. من قال إنّه صُنِعَ للمجد؟ ربّما شُيِّدَ ليخبّئ الخيبةَ في داخله تلك التي لا تُقال بل تُرتّب حجراً فوق حجر، حتى تصبح الحياةُ معماراً يُرهِقُنا تفسيرُه. في هذا الصرح لا شيء يعلو بل كلُّ شيءٍ يغوص: الصوتُ يغوصُ في الصمت، والنورُ في الظلال، والأملُ في المعنى الذي لم يكتمل. الخيبة كما كتبها #عمر_أحمد_الحمود
لم تكن قصة بل خريطةُ متاهةٍ تشبه حجراً مفقوداً في قلب الهرم.
كلُّ جملةٍ فيها لبنة، وكلّ صمتٍ ممرّ، وكلّ مشهدٍ درجٌ نحو الأسفل، حيث لا شيء يُفضي إلى مخرج، إلّا الذات، حين تتصادمُ بأقصى ما ظنّت أنها تجاوزته. كلُّ من وقفَ أمام الهرم، حسبهُ جبلًا. وحده من مرَّ بـ”الخيبة” رآهُ كومةً من صلواتٍ منسيّة، وصدى صرخاتٍ لم يسمعها أحد، ومجموعةً من الأحلام التي تعفّنت بهدوءٍ تحت البلاط المقدّس. كان عمر في “الخيبة” يهدم البيت من داخله، تماماً كما يتهاوى النور في قلب الهرم دون أن يخرج. وكان الصمتُ لغته، كما هي لغةُ هذا البناء الجبار: لا يُعطي تفسيراً، لا يفتحُ باباً، لكنه يُشعِرُك بثقلٍ داخليٍّ لا مفرّ منه. من الخارج هو أعجوبة، من الداخل هو اعترافٌ خافتٌ، أنَّ ما يُدهِشُ العالم، قد يُرهقُ من بناه.
النص أعلاه لا يصف الهرم بل يقرأه كرمزٍ متجلٍّ عن الخيبة النفسية كما جسّدها عمر أحمد الحمود في عمله القصصي الخيبة. الهرم هنا ليس معماراً خارجياً، بل صورة للذات حين تُشيّد خيبتها طبقةً فوق طبقة، دون أن تسقط، ودون أن تُشفى. هو أيضاً استعارة للقصّ الذي لا ينفجر، بل يضغط بهدوء – كما يفعل عمر – حتى تتحول الخيبة إلى بناءٍ من الداخل، لا يُنسى ولا يُهدم.
#المرآةالثانية: #حدائقُ_بابل_وسقوطُ_هرقلة
(تأمل في “هرقلة” لعمر أحمد الحمود)
لم تكن حدائقُ بابل فردوساً بل محاولةً مستميتةً لتزيينِ الجرحِ بالزهور. من قال إنّها بُنيت لتُبهر؟ ربّما رُفِعَت في الهواء لا كي تُرى.. بل كي تختبئ عن الأرض، عن جذرها، عن السقوط الذي ينتظرها في آخر الحكاية. في كلّ شرفةٍ خضراء، كان هناك ظلٌّ يخشى الضوء، وفي كلّ غصنٍ متدلٍّ وعدٌ مؤجلٌ بالسقوط.
“هرقلة”، كما كتبها عمر أحمد الحمود، ليست مدينةً تنهار، بل ذاتٌ تُسقطُ نفسها قطعةً قطعة في محاولةٍ يائسة لإعادة اكتشافها من خلال الانهدام. لم تكن الحكاية عن أطلال، بل عن التكوين وهو يُعيد مساءلة ذاته. الحدائقُ هنا ليست حياةً تنمو، بل وهماً يُزهِر على جسدٍ مائل، لا ليستقيم، ولا ليقع تماماً.
كلّ مشهدٍ فيها نباتٌ متسلّقٌ على جدارِ خيبة، كلّ تفصيلةٍ محاولةٌ للتماسك وسط الريح، وكلّ صوتٍ فيها صدى يُعيد على الذات سؤالها الأول: من أين بدأتُ، ولماذا لم أصل؟ . “هرقلة” كانت تفكيكاً معمارياً لما نظنّه مجداً .. مدينةٌ تسير إلى الخلف، حتى تتعثر بنفسها. لا بطولات، لا ملاحم، بل هسيسُ قلبٍ يشبه أوراق الشجر حين تذبل بصمت.وكان عمر في “هرقلة”، لا يهدم كما في “الخيبة”، بل يخلع الطلاء طبقةً طبقة، حتى يترك الجدار عارياً من كلّ تزيين. وكان النصُّ كحدائق بابل معلقاً بين السماء والأرض لا يصعد، لا ينزل، بل يبقى شاهقاً في تردّده، خائفاً من أن يُزهر أكثر… فينهار. من الخارج، “هرقلة” حكايةٌ عن مدينة. من الداخل، هي أنا وأنت حين نتقن السقوط دون أن نعترف به، وحين نتعلق بجمالٍ نعرف أنه هشّ، لكنه جميل بما يكفي لنستمرّ في الحلم.
النص أعلاه لا يصف “هرقلة” كمدينة أو قصة، بل يقرؤها كمرآة رمزية للانهيار الداخلي، كما جسّدها عمر الحمود في عمله القصصي. حدائق بابل هنا ليست أعجوبةً عمرانية، بل استعارة عن الزينة التي نعلّقها على هشاشتنا النفسية. و”هرقلة” ليست سقوطاً مأساوياً، بل انكشافٌ بطيءٌ للذات حين تُدرك أن تماسكها لم يكن يومًا سوى وهمٍ بارع.
#الْمِرْآةُالثَّالِثَة:#زِيُوسُ_الَّذِي_هَدَّهُ_الْقَصَاصُ
(تأمل في “الخيبة” لعمر أحمد الحمود)
لم يكن زيوسُ إلهاً كما يُروى، بل وهماً قديماً اعتقد أن الرعدَ يكفي لإقناع السماء بالبكاء. لم يكن يمشي، بل يَعلو، حتى خُيّل له أن الأرضَ نسيت وزن خطاها. من قال إنّ زيوس يُنزل العدالة؟ ربّما كان يسحب البرقَ ليحرق به من قالوا “لا”. وربّما بنى عرشه من عظامِ من طالبوا بحقه. في هذا التجلي، لا أحد يُحاسِب، بل الجميع يُراقب، لا أحد يَدين، بل الجميع ينتظر. حتى القصاص جاء بطيئاً بوجهٍ يشبه المرآة، لا السيف. فزيوس لم يسقط من عرشه، بل رأى نفسه عليه، وهو يتهاوى قطعةً قطعة، لا بسيفٍ ولا انقلاب، بل بنظرةٍ لم يَعرف كيف يُطأطئ لها رأسه. “الخيبة” في عالم زيوس، لم تكن فشلًا، بل نظاماً. والعدل لم يكن ميزاناً، بل مشهديّة مدروسة، لإقناع الضحايا أن الجاني هو المنقذ. لكن القصاص كما كتبه عمر، لم يأتِ ليكسر زيوس، بل ليُريه نفسه كما يراها الآخرون: إلهاً بلا إلهية، وسيداً نسي كيف يكون بشراً. كل جملةٍ في القصاص كانت محاكمة، وكل صمتٍ فيه شاهد، وكل اِلْتَفاتةٍ نحو الماضي كانت صاعقة لم يُطلِقها زيوس، بل تلقاها. ذلك البرق الذي أخفاه عن الجميع، سقط عليه من داخله. وكان الصوت، لا صوت الرعد، بل صوت من نطقوا باسمه وهم يطلبون الخلاص، ثم سقطوا واحداً تلو الآخر، دون أن يلمحهم من أعلى.
“القصاص” في مرآة عمر ليس نهاية. بل بداية لما بعد سقوط العرش، لما بعد انكسار الأسطورة. حين يصبح الصمت أكثر ارتفاعاً من الرعد، وتصبح المرايا أصدق من الميثولوجيا.
لا تصوّر هذه المرآة زيوس ككائن ميثولوجي، بل كتمثيل رمزي للسلطة المطلقة حين تنسى إنسانيتها. والقصاص كما جسّده عمر أحمد الحمود، ليس انتقاماً، بل حالة كشف داخلي صارخ، حين يُجبر المتسلّط على النظر في ما فعله لا بعيون ضحاياه، بل بعين المرآة التي لا تُكذّب.
زيوس هنا ليس فوق القانون، بل أمام المرآة. والمرايا لا تُصدر الأحكام، بل تُجبرك على مواجهتها.
#الْمِرْآةُالرَّابِعَة: #منارة_الإسكندرية_ومعراج_الصحو
(تأمل في “معراج الصحو” لعمر أحمد الحمود)
لم تكن منارةُ الإسكندرية مجردَ برجٍ يرشد السفن، بل كانت إصبعاً من ضوءٍ يشيرُ إلى داخل الإنسان، لا خارجه. ما ظُنَّ أنه وسيلةٌ لهداية البحر، كان سرّاً في كيفية الخروج من التيه النفسي. لم تُبنَ لتكشف اليابسة، بل لتسحب الغريق من غفلته إلى وعيه، ومن التكرار إلى الانتباه. في “معراج الصحو”، لا يدعونا عمر للصعود كمن يتسلّق، بل كمن يتذكّر. النصّ لا يقدّم وصايا، بل يُضيء. لا يُعلّم، بل يُوقظ. كل مشهد فيه يشبه شعلةً تشتعل فجأة في عتمة الذاكرة، وكل جملة مثل نافذةٍ تُفتَح على ضوءٍ لم نره من قبل، لا لأنه غائب، بل لأننا أغمضنا أعيننا طويلًا. كانت المنارة، في نصّه، تَشعّ لا لتدلّ على الميناء، بل على مَنكبٍ داخليّ علينا أن نلتفت إليه. كانت تصعد من الأرض لا إلى السماء، بل إلى لحظةٍ نادرة.. أن يصحو المرء من حياته، لا من نومه فقط. ومعراج الصحو لم يكن انتقالًا إلى الأعلى، بل انقلاباً هادئاً في داخل الذات – يشبه النور حين ينسكب ببطء على غرفةٍ مغلقة منذ سنين، فينكشف ما فيها من غبارٍ وكتبٍ وحكايات مؤجلة.
عمر لم يكتب قصة يقظة، بل بنى سلّماً من الدهشة. كل فقرةٍ فيه درجة، وكل درجة انكسارٌ جميل في مرآة الوعي. ما إن تنتهي، حتى لا تعود كما كنت.. أنتَ أنتَ، لكنك تراها الآن – المرايا، المنارات، والعتمات – كما لو أنك لم ترها من قبل.
هذه القراءة لا تتعامل مع المنارة بوصفها معمارا ً أثرياً، بل بوصفها رمزاً للانتباه الذي يكسر سبات النفس.
في “معراج الصحو”، يصبح النور بطلاً صامتاً، لا يصرخ، بل يلمس. والصحو لا يُفرض، بل يُقترَح: على القارئ أن يرى، أن يصعد، أن يستفيق . . لا بأمرٍ خارجي، بل بنداءٍ داخليٍّ يشبه الضوء حين يتكاثر في القلب.
#المرآةالخامسة: #ضريح_موسولوس_وكابوس_الماء
(تأمل في “كابوس الماء” لعمر أحمد الحمود)
ضريح موسولوس ليس قبراً، بل اعترافٌ حجريٌّ بأنّ الحُبَّ أقوى من النسيان.
كلُّ حجرٍ فيه قُبلةٌ مؤجّلة، وكلُّ تمثالٍ نُدبةٌ على جبهة الخلود. لم تكن أرتيميسيا تبكي موسولوس، بل كانت تُشيّد له معبداً من صبرها. ذاك هو العشقُ حين يتّخذ شكلَ معمار: لا يُسكن، بل يُعبد. لم يكن ضريح موسولوس شاهداً على العشق، بل صرحاً شُيِّد ليحرس رعباً لا يُرى. ذاك الذي يسكن فينا، ويتسلل كلّ مساء عبر حواسنا دون أن يطرق. الضريح، تماماً كما في “كابوس الماء”، لا يُقام على جسد، بل على سؤال معلّق في الهواء: لماذا حين نغرق لا نختنق، بل نخرس؟
في عالم “كابوس الماء”، لا تهمّ الأقدام اليابسة، ولا تعني القوارب المتاحة شيئاً، لأن الطوفان الذي يتحدث عنه الحمود لا يأتي من السماء، بل ينبع من تحت الجلد، من هشاشة الوعي، ومن اختناق الروح بكتمان الحقيقة. هذا الماء الذي لا يُطفئ العطش، ولا يُغسل به القلب، هو ذاته الذي يضغط على الأعناق بكابوس لا يترك أثراً، لكنّه يفسد الحلم من جذوره. كلّ قصةٍ في المجموعة تشبه حجراً في ضريح موسولوس، منحوتاً بإتقان، نعم، لكن خلف الجمال الفنيّ تكمن المرارة: مرارة أن تكون مُراقَباً، مُطارَداً، مُهدَّداً، لا لأنك قاتلت، بل لأنك فكرت، لا لأنك أنكرت، بل لأنك قلت “لا” للماء الذي يعمّدنا بالخوف. عمر الحمود لا يروي حكايات، بل يكشف مستنقعاً مائيّاً يتقن التنكر في صورة نهر. صمتٌ يسيل على هيئة سرد، وتعبٌ يتقطّر من كل جملة، وحقٌ يُطلُّ خائفاً من خلف الستائر. قصصه تشرّح المجتمع، نعم، لكنها تشرّح القارئ أولًا. في “كابوس الماء”، لا خلاص دون اعتراف، ولا اعتراف دون خطر، ولا خطر دون يقين أن قول الحقيقة صار عبوراً فوق الماء لا يُسمَح لنا به.
الضريح هنا ليس مأثرة فنّية، بل غطاء رخاميّ لوحش مائيّ يُخيف أكثر مما يؤلم. الماء في نصوص الحمود ليس نهراً، بل سلاحاً، وعيون الليل ليست مجازاً، بل وقائع تتربّص، وتوثّق، وتخنق. في “كابوس الماء”، يُصبح السرد مقاومة،
والكلمة عتبة للغرق، لكنها أيضاً طريق النجاة الوحيد، لمن يتجرّأ أن يسبح ضد التيار، حتى وإن وصل مبلّلًا بالحقيقة، لا بالماء.
#المرآةالسادسة: #تمثال_رودس_العملاق_وهبوب_السموم
(تأمل في “هبوب السموم” لعمر أحمد الحمود)
لم يكن تمثال رودس العملاق حارساً للميناء، بل شاهدةً ضخمة على ما لا تستطيع السفن حمله.. الخوف من الزوال.لم يُبْنَ التمثال ليقف، بل ليُثبت للريح أن الإنسان قادرٌ على الوقوف، حتى لو تخلخلت تحته الأرض. من قال إنّه بُني للبطولة؟ ربما ارتفع فقط ليُخفي تحت قدميه فوهةً من العزلة والخراب. هذا ما تفعله الرياح حين تهبُّ في أرضٍ مغلقة: لا تقتلع البيوت، بل تفضح الأسقف. ورواية “هبوب السموم” ليست قصة حب فقط، بل خريطةٌ للريح وهي تمرّ في الأزمنة والقلوب، دون أن تعتذر عن الغبار. في “هبوب السموم”، لا تمشي الشخصيات فوق الأرض، بل فوق طبقات من التقاليد الثقيلة، والخيبات الصلبة، والعوائق التي تتخفى خلف الكلمات. العاشقان لا يهربان من الريف، بل من صوتهِ وهو يُملي عليهما ما لا يجوز، وما لا يُغفَر. وحين يُسجن البطل، لا يُحبَس الجسد فقط، بل يُختبَر الحنين. هل يمكن للحب أن يبقى حيّاً، في قلبٍ يُطارده الزمن، ويُربكه الماضي، ويخذله الحاضر؟ وهل يمكن للذاكرة أن تفتح نوافذها للريح، دون أن تفقد توازنها؟ تمثال رودس ليس صامداً لأنه قوي، بل لأنه هشٌّ بما يكفي ليعرف كيف يواجه الكسر دون أن يُهشم الآخرين. كلّ مشهدٍ من “هبوب السموم” يشبه رقبةَ التمثال: مرفوعةٌ عنوةً، لكنّها تترنح تحت ثقل الصمت.
وكلّ فصلٍ فيها، خطوةٌ في دربٍ من الطين الممزوج بالماء والدمع والولاء. كان عمر الحمود في هذه الرواية يُدوِّن تاريخاً لا بالأحداث، بل بالنَفَس. يرسم الشخصيات كما تُرسم الصخور التي لم تُنحت بعد، وكلّ ما فيها يوحي بأن النهاية ليست قفلاً، بل مرآة مائلة تُعيد للقارئ صورته حين ظن أنه نسي الحب.
التمثال هنا ليس أيقونة نصر، بل وثنٌ هشٌّ للعشق حين يصمد رغم هشاشة الأرض من تحته. وهبوب السموم ليس ريحاً طبيعية، بل ذاكرة عميقة تنفخ في القلب لتختبر صلابته. في “هبوب السموم” لا يقف الحب في وجه العادات فحسب، بل في وجه التاريخ حين يتحوّل إلى سجن، ويظلُّ وفياً، لا لأنه بريء، بل لأنه اختار الطُهر، رغم كلّ ما في الريح من رماد. هذه الرواية لا تُغلق أبوابها، بل تتركها مواربة، كأنها تقول: كلّ نهايةٍ مفتوحة، إذا ما أحببت حقّاً.
تماماً كما يفعل التمثال حين ينهض من الملح، لا ليراقب السفن، بل ليقول للريح: أنا أيضاً أحببت، ولم أسقط.
#هيكل_آرتميس_وعزفٌ_بأنامل_عاشقة
(تأمل في “عزف بأنامل عاشقة” لعمر أحمد الحمود)
لم يكن هيكل آرتميس معبداً للحجر، بل أغنيةً هائلةً كتبتها الأصابع على جسد الأرض. من قال إنه بُني لتعبد الآلهة؟
ربّما شُيِّد ليعزف المحبّون صلواتهم، لا بالخوف، بل بالندى. كلّ عمود فيه يشبه أنثى واقفة، شامخة، لا تنتظر من يحررها، بل من يراها. في “عزف بأنامل عاشقة”، لا تُكتب المرأة، بل تُعاش. ليست مجازاً عابراً ، بل كياناً كاملًا، تنهض من الحروف كأنها الحياة حين ترفض أن تجف، وتسكن السرد كما تسكن الروح ظلّها. هذا الهيكل، كما هي المجموعة، لا يُبنى من حجر، بل من لمسات شعوريّة تراكمت، من نَفَسٍ طويل يصرّ أن الحب ليس تمرّداً، بل طقسُ ولادةٍ جديدة في زمن مَطمور. الأنامل لا تعزف على وتر الجسد، بل على نبض الأمومة، وظلّ الصداقة، وهمس الندّ،
كأن كلّ قصة تخرج من حنجرة امرأة تغنّي لا لتُطرب، بل لتُشفى.
في “عزف بأنامل عاشقة”، لا يتخفّى الحب، بل يُعلن نفسه كفعل تحرر للاثنين معاً: المرأة والرجل، المكان والذاكرة، الرقة وحنينها البعيد. والسرد هنا ليس غرضاً جماليّاً، بل وسيلة تنفسٍ في هجيرٍ اجتماعيٍّ يتّسع على الجسد ويضيق على القلب. كلّ مشهدٍ في المجموعة طقسٌ من التقديس: الأنثى معشوقة، ولكنها أيضًا مدينة، فرات، حلم، بيت، غيم، وملاذ. وكلّ عبارةٍ تخرج كأنها محاولة لاستعادة توازن مفقود، أمام طوفان القبح، في عالمٍ لم يعد يعترف بالجمال إلا خلسة. هيكل آرتميس لا ينهض إلا ليقول: الأنوثة ليست ضعفاً، بل إيقاعٌ يُبقي الأرض معلّقة فوق هاوية الكراهية.
وعمر، في هذه المجموعة، لا يعزف فقط، بل يقدّس. لا يصف امرأة، بل يعيدها إلى مقامها: الذي لا يُلمس، بل يُبجّل.
الهيكل هنا ليس معماراً أثريّاً، بل استعارة لسردٍ يُعيد تشكيل صورة المرأة في وعيٍ يُقاوم الذبول. و”عزف بأنامل عاشقة” لا يُلحن قصة حبّ، بل يُبني كحياةٍ أخرى تُكتب بالحبر كي لا تُمحى. المرأة ليست موضوعاً، بل مقامٌ أعلى، والعزف هنا ليس ترفاً لغوياً، بل نداء داخليّ يُصرُّ أن الحياة لا تُطاق دون جمال، ولا معنى لها دون أنثى تُضيء المعنى.